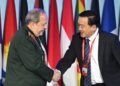أظهرت البيانات الرسمية الصادرة بعد اللقاءات أن قضية مستقبل الأسد لم تمثل حاجزاً يعيق استكشاف إمكانيات التنسيق القادم عبر مختلف الميادين السياسية والتجارية والدفاعية والأمنية.
على الرغم من أن زيارة أحمد الشرع لم تسفر عن نتائج ملموسة فورية، إلا أنها مثلت خطوة أولية محسوبة نحو إعادة إرساء دعائم الثقة المتبادلة بين العاصمة السورية والكرملين في أعقاب انهيار سلطة بشار الأسد. يجب الإشارة إلى أن الملفات الشائكة التي تفصل بين الطرفين تتسم بالتعقيد البالغ، وتتضمن مصير المنشآت العسكرية الروسية المتواجدة على الأراضي السورية، ومآل العقود الاقتصادية والعسكرية التي أبرمت سابقاً، والالتزامات المالية المتراكمة من الحقبة الماضية، إضافة إلى ملف المحاسبة والعدالة الذي يشمل تسليم الأسد وعدد من القيادات العسكرية والمدنية البارزة الذين استقر جزء منهم في العاصمة الروسية بعد منحهم حق الحماية الدولية.
عند التمعن في التصريحات الرسمية التي أدلى بها الزعيمان في مستهل الاجتماع، يتضح أن هناك توافقاً ضمنياً على تجنب الخوض علناً في القضايا الأكثر حساسية وإيلاماً. اقتصر النقاش المعلن على التأكيد على الروابط التاريخية الممتدة، والمنافع المشتركة بين البلدين، مع تحديد المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي. على نقيض التوقعات التي سادت قبل اللقاء، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أن قضية مستقبل الأسد، الحاكم المعزول واللاجئ المقيم على مسافة قصيرة من مركز السلطة الروسية، لم تمثل حاجزاً يعيق استكشاف إمكانيات التنسيق القادم عبر مختلف الميادين السياسية والتجارية والدفاعية والأمنية، وهو ما يتجلى من خلال تركيبة الوفود المشاركة من كلا الجانبين في المباحثات. من المحتمل بشكل كبير أن ملف الأسد لن يشكل عائقاً فعلياً أمام تقدم العلاقات بين الكرملين ودمشق الجديدة. القيادة السورية الراهنة تواجه تحديات أكثر إلحاحاً وأولوية تشمل تثبيت أركان الحكم والسيطرة على الأوضاع الداخلية المتقلبة، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين. ربما رأت القيادة السورية الحالية أن قبول موسكو بالمساهمة الإيجابية في بناء مستقبل البلاد يفوق بكثير أهمية التمسك بملف تسليم الأسد، وهي قضية تمثل حرجاً سياسياً كبيراً للرئيس بوتين الذي قرر منح الأسد حماية إنسانية.
رغم أن بناء العلاقات الروسية السورية على قواعد مختلفة يمثل حاجة ملحة للجانبين، فإن القلق من ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية يعتبر من أبرز المعوقات التي تقف في طريق ذلك.
بالإضافة إلى الملفات المعلنة للنقاش، فإن حضور إيغور كوستيكوف، قائد الاستخبارات العسكرية الروسية، ضمن الاجتماعات يكشف أن الطرفين تناولا موضوع مكافحة الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تضم عناصر من روسيا ودول آسيا الوسطى، ومنع رجوع هؤلاء العناصر إلى أوطانهم الأصلية ونشر أيديولوجياتهم أو استقطاب مجندين جدد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الروسية، وهو الهدف الذي أعلنه الرئيس بوتين كمبرر للتدخل العسكري في عام ألفين وخمسة عشر من خلال استهداف الإرهابيين في سوريا لمنع انتقال الإرهاب إلى المدن الروسية. من ناحية أخرى، تستطيع الاستخبارات العسكرية الروسية، بما تمتلكه من أرشيف هائل جمعته خلال سنوات انخراطها في الملف السوري وعلاقاتها الممتدة مع ضباط الجيش السوري والقوات الإيرانية على مدى سنوات طويلة، أن تقدم الدعم للسلطة الجديدة في دمشق للحد من تحركات بقايا النظام السابق الذين اختاروا البقاء في البلاد بعد فرار الأسد. يمكن أن يلعب التنسيق الاستخباراتي بين الجانبين دوراً في إفشال عمليات إرهابية منفردة، أو تحركات لقوى ترفض الحكم الجديد، أو تسعى لإثارة الفوضى لتبرير عدم رغبتها في الانخراط ضمن الكيان السياسي الجديد. مع الانتشار الروسي في شمال شرق سوريا، فإن الحكم الجديد في أمس الحاجة إلى دعم الجيش الروسي في عملية الوساطة مع قوات سوريا الديمقراطية وربما القيام بدور أوسع من ذلك.
من المعروف أن آلاف المقاتلين من جمهوريتي الشيشان وداغستان التابعتين لروسيا، وبلدان آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وطاجيكستان شاركوا في القتال في سوريا ضمن فصائل مستقلة، وانضم مئات من عناصرهم ضمن كتائب في هيئة تحرير الشام، وبقي قسم منهم في تنظيمات صغيرة أكثر تشدداً أو يقاتلون في صفوف تنظيم داعش. في المقابل، ادعت تقارير أن ضباطاً موالين للنظام السابق ومتواجدين في موسكو قاموا بالتنسيق لتمرد في المنطقة الساحلية في فصل الربيع من العام الحالي، والذي أسفر عن أحداث مؤسفة وانتهاكات جسيمة.
إذا كان من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على ما قد ينتج مستقبلاً عن زيارة الشرع، فإن اللافت أن الطرفين أبقيا الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات على الاتفاقيات الموقعة والتي أعلن الشرع التزامه بها، بما يتوافق مع المرحلة الجديدة. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حوار مع قناة الإخبارية السورية في الثامن عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري أن التعامل مع روسيا تمّ بشكل تدريجي، ولم تُبرم أي اتفاقيات جديدة، في حين تبقى الاتفاقيات المبرمة مع النظام السابق معلقة، لأننا لا نوافق عليها بشكلها القديم. وهو ما يمكن اعتباره قاعدة لاختبار مدى الثقة وإعادة تحديد المصالح بين الطرفين ضمن واقع إقليمي ودولي متحول.
في هذا الإطار، أكد الشيباني في المقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن السياسة الخارجية السورية اليوم تبتعد عن الاستقطاب والمحاور، وتتبنى الحوار والانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع، مضيفاً أن دمشق تتعامل مع الملف الروسي بعقلانية وحذر، انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التبعية أو الارتباط.
تعكس تصريحات الشيباني مفاهيم مختلفة تستند إليها السياسة السورية الجديدة، وتنطلق من الانفتاح المتوازن المبني على الواقعية السياسية بهدف بناء الشراكات مع الدول الأخرى على أساس المنفعة الوطنية لا الانحياز السياسي. إلا أن تحقيق معادلة الابتعاد عن الاستقطاب والمحاور والحوار والتعاون المتوازن مع الجميع، يبدو معقداً في التطبيق الفعلي.
رغم أن بناء العلاقات الروسية السورية على قواعد مختلفة يمثل حاجة ملحة للجانبين، فإن القلق من ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية يعتبر من أبرز المعوقات التي تقف في طريق إعادة بناء العلاقات السورية الروسية، خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي.
الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتخوف من أن تصبح سوريا ممراً جانبياً للتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو، لا سيما في قطاعات البترول والغاز والمعادن والبنوك.
في المجال العسكري، تجد دمشق نفسها مضطرة للتنسيق مع روسيا والصين وتركيا لإعادة بناء قدراتها الدفاعية التي تضررت خلال سنوات الصراع، وقضت إسرائيل على معظمها بعد سقوط النظام السابق، في ظل استحالة الاعتماد على الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. من غير المرجح وجود استعداد لدى الغرب لتزويد سوريا بأي منظومات دفاعية أو تقنية عسكرية متطورة، ويربط أي تعاون أمني بشروط سياسية تمسّ جوهر السيادة السورية.
يعد التوجه نحو روسيا والصين الخيار المتاح واقعياً، وتفرضه احتياجات الأمن القومي واستعادة توازن الردع أكثر مما تفرضه التحالفات التقليدية، مع ما يستتبع ذلك من حذر في إدارة هذه الشراكات لتجنب إثارة حساسيات الغرب أو تهديد توازنات الاستقرار الإقليمي. في هذا السياق لا يوجد يقين مطلق بأن روسيا تجمع بين الرغبة والقدرة على تزويد سوريا باحتياجاتها العسكرية الكاملة على المدى المنظور بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا.
يبرز في هذا الإطار العامل الإسرائيلي باعتباره أحد أهم محددات الموقف الغربي من إعادة بناء القدرات الدفاعية السورية. إذ تتمسك واشنطن والعواصم الأوروبية، إلى حد معين، بمراعاة المطالب الإسرائيلية، فإدارة ترامب اعترفت بضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة، وتشترك مع دول الاتحاد الأوروبي بالسعي للحد من أي تطوير نوعي للقدرات الصاروخية أو منظومات الدفاع الجوي السورية، ما يجعل أي تنسيق سوري مع الولايات المتحدة أو الغرب في المجال العسكري بما يلبي الحاجة السورية شبه مستحيل.
أما في المجال الاقتصادي، فإن إمكانية اعتماد حكومة الشرع على الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد السوري يواجه عقبات بنيوية واضحة. فالانفتاح النسبي الأمريكي والغربي على حكومة الشرع ما زال يتصف بالحذر، والعقوبات لم تُرفع بالكامل حتى الآن، والاستثمارات الغربية ما زالت مشروطة بإصلاحات سياسية عميقة يصعب تحقيقها في الأمد القريب.
في المقابل، لا يمكن الرهان على روسيا في القضايا الاقتصادية والاستثمارية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. خلال زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إلى دمشق في سبتمبر أيلول الماضي، عرضت موسكو المشاركة في إعادة إعمار قطاع الطاقة والمجال الإنساني. بناءً على نتائج مباحثات بوتين والشرع الأخيرة، وافقت روسيا على دراسة إمكانية توريد القمح، الأدوية والمواد الغذائية إلى سوريا، والعمل في حقول البترول.
رغم أن هذه القطاعات غير كافية لتحسين الأوضاع، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتخوف من أن تصبح سوريا ممراً جانبياً للتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو، لا سيما في قطاعات البترول والغاز والمعادن والبنوك. من هذا المنظور، يبقى أي تقارب اقتصادي أو عسكري بين دمشق وموسكو خاضعاً لمراقبة دقيقة، لكن تعزيز العلاقات السورية مع روسيا يشجع الصين على ضخ أموال في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا والاستثمار في بعض القطاعات.
مجمل التعقيدات السابقة تضع حكومة الشرع أمام معادلة بالغة التعقيد. فهي تسعى إلى تنويع شراكاتها والانفتاح على الجميع، لكنها مضطرة في الوقت ذاته إلى التعامل بواقعية مع موازين القوى الدولية التي لا تمنحها سوى هامش محدود للحركة. من المؤكد أن نجاح دمشق في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين ضرورات الأمن ومتطلبات السيادة وإعادة الإعمار وتنشيط اقتصادها سيحدد شكل علاقاتها المستقبلية مع الشرق والغرب، ويكشف إلى أي مدى يمكن للسياسة السورية الجديدة أن تحقق استقلالها دون عزلة، وانفتاحها دون ارتباط، وهنا تكمن صعوبة تحقيق المعادلة التي تحدث عنها الشيباني.
اجتماع موسكو يمثل بداية فصل جديد في العلاقات السورية الروسية، عنوانه الضرورة المتبادلة.
من المؤكد أن زيارة الشرع أصبحت نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الروسية السورية، مبنية على مصالح متبادلة. القيادة السورية الجديدة بحاجة لتعزيز شرعيتها، وكذلك حل المشاكل الاقتصادية والأمنية، التي تستطيع موسكو المساهمة في التخفيف منها على الأقل. من جهته، تمثل لقاءات بوتين مع الشرع فرصة للحفاظ على ماء الوجه بعد سقوط نظام الأسد، وإظهار أن روسيا لا تزال حاضرة في الشرق الأوسط. لكن قيام روسيا بالأدوار السابقة فيما يخص الحد من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب يبدو مستبعداً، فالوجود الروسي في جنوب سوريا قبل تغيير السلطة في دمشق كان يخدم المصالح الإسرائيلية، والدوريات الروسية كانت مكلفة أساساً بمنع انتشار الجماعات الموالية لإيران في جنوب سوريا. رغم أن إسرائيل تفضل بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس خشية انفراد تركيا بقواعد عسكرية في شمال سوريا، فإن المواقف الأوروبية تربط مساعدة الحكم الجديد بقطع العلاقات مع روسيا، كما أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى تقاسم نفوذها الذي اكتسبته مع موسكو، أو أن تملأ روسيا الفراغ في منطقة الجزيرة السورية في حال قررت إدارة ترامب الانسحاب.
في الجزء المفتوح من القمة، قال الشرع إننا نسعى إلى استعادة وإعادة تحديد طبيعة هذه العلاقات بطريقة جديدة، بما يضمن استقلال سوريا، وسيادة سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها، واستقرارها الأمني. أعطى حديث بوتين وتصريحات المسؤولين الروس لاحقاً الشرع نظرياً كل ما يريد، فقد أثنى بوتين على انتخابات مجلس الشعب وأكدت روسيا على رفض الحركات الانفصالية ودعم وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأخيراً، فإن اجتماع موسكو يمثل بداية فصل جديد في العلاقات السورية الروسية، عنوانه الضرورة المتبادلة. لكن استعادة العلاقة لا يرتبط فقط بطي صفحة الماضي، على صعوبة الأمر، بل يتجاوزه إلى تأثير الواقع الإقليمي والدولي على الأوضاع في سوريا، وحجم الموارد الاستراتيجية التي يمكن أن توجهها روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل انشغالها بحرب وجودية في أوكرانيا.